هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
الذاكرة السياسية
الحركة الإسلاميّة التونسية في مهبّ القرن الجديد.. عن إسلام السلطة والجماعة

ليس في كتاب الصّحفي لطفي حجّي مدير مكتب قناة الجزيرة بتونس
"إسلام السلطة وإسلام الجماعة" من جديدِ عادات أهل الصحافة من تجميع
مقالات وترتيبها على شكل محاور وأبواب، لا على حسب ظهورها التاريخي في الدوريات
والندوات، غيرُ ذاك التّماس الخطير بين ما هو سياسي وما هو فكري، وبين ما هو
عقائدي وما يضغط به الواقع المتحوّل. ويُحسب للكاتب والكتاب أنّه شاهد ثبتٌ قيّمٌ
على ما شهدته الساحة التونسيّة من بدايات القرن حتى سنة 2016 في أقرب إحالة زمنية.
لطفي حجّي هو خرّيج معهد الصحافة التونسيّة مؤلّف كتاب "بورقيبة والإسلام: الزعامة والإمامة" (2004) الذي وقعت ترجمته إلى الفرنسية سنة 2011 كما شارك في مؤلّف جماعي حول "بورقيبة: البصمة والأثر" مثلما ساهم في مؤلف جماعي حول مراجعات الإسلاميين سنة 2010 وفي تقارير حول حرية الإعلام وكان أحد مؤسسي هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات سنة 2005 التي أقامت أوّل منبر بتونس للحوار بين الإسلاميين والعلمانيين وبادر بصياغة نصوصها المرجعية حول المساواة بين الجنسين وحرية الضمير والمعتقد والعلاقة بين الدين والدولة التي تحوّلت إلى مبادئ دستور 2014 لتونس بعد الثورة.
الكتاب
يتضمّن مقدمة وستّة أبواب في تعدد أفهام الإسلام وعلاقة مقولة الشورى بالديمقراطية وما طرأ على فهم الجماعات للإسلام من مراجعات قبل ثورات الربيع العربي وبعدها. ثمّ يقارب ظاهرة التكفيريين ليضعنا أمام "تيه المسلم " اليوم بين النص والعقل/ التأويل والواقع لينتهي عند أفق تجديد الفهم الديني. الكتاب متوسّط الحجم يقع في 404 من الصفحات وهو يتدرّج منهجيا من تفكيك المقولات الكبرى للفكر الإسلامي إلى ما صدق عليها من وقائع في أسلوب صحفي دقيق العبارة حذر التأويل رصين الاستنتاج.
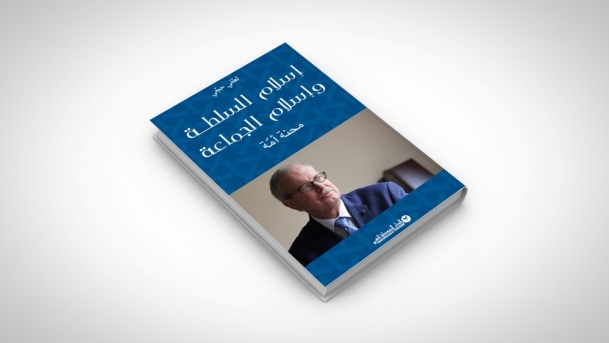
يأخذ الكتاب بمسألة حضارية غاية في الأهميّة، هي "محنة أمّة" يلخّصها الكاتب في قوله " مأزق فهم الإسلام في ديار الإسلام" كما ورد في المقدّمة. ومن هناك يفتح أبوابا ظلّت مواربة لم يُحسم فيها قول بلّ زادت تعقيدا مع ظهور الفهم الدموي للعقائد كأنّنا في زمن "حسن الصباح" والحشاشين.
الإسلام الواحد والأفهام المتعددة
يُفتح الباب الأوّل على المفارقة: الإسلام الواحد والأفهام المتعددة. بما يؤشّر على تأصّل الاختلاف المذهبي والعقائدي والسياسي وبدايات ظهور فكرة "الفرقة النّاجية" التي شرّعت للتقاتل والتناحر بتوظيف التأويل والفهم الحدّي للإسلام. ولكن هذه الحديّة لم تسلم منها السلطة السياسية المعاصرة ولا الجماعات الحاملة للفكرة الدينية. وكلاهما بشكل أو بآخر يوظّف الدين لصالحه ويفهمه على طريقته ويستعدي به الفهم الآخر. عند هذا الحدّ يطرح المؤلّف مسألة الحريّة باعتبارها الضامن الوحيد لتجنّب ما سماه "التضليل الفكري": "فالحرية الدينيّة ستسمح بتعايش التأويلات والاجتهادات دون أن يحتكر طرف ـ جماعة أو سلطة ـ حق تأويل الدين وتقنين التفكير حوله" ( ص31).
الديمقراطية والشورى
يتضمّن هذا الباب اختبارات فكرية لمقولات الليبرالية المعولمة في الدين والسياسة ومنها فقه الشورى ومؤسسات الديمقراطية، ومنها "الفريضة الغائبة" من الديمقراطية المغشوشة، ومنها فكرة المواطنة في ظلّ نظم تيوقراطية أو عسكرية ترى في مواطنيها رعايا، ومنها ما طرأ على الدول الوطنية من انحرافات نحو التسلّط والغنائمية في تعاملهم مع السلطة والدولة.
زمن المراجعات
هذا العنوان يجمع بابين وهما الثالث والرابع من الكتاب. ينطلق الكاتب من مقدّمة قائمة على خيارين وجدت الحركات الإسلامية نفسها أمامهما وهما: إمّا بناء خطاب بوعي نقدي من أجل رؤية تأليفية تذيب تناقضات الأمس أو أن تختار تيارا سواء رسميا أو معارضا( سنّي أموي أو خارجي أو غيرهما) واعتبار نفسها امتدادا له. ولقد اختارت الثّاني ف"ساهمت في تعقيد المعادلة بدل حلّها"(ص118). من هنا يعرض الكاتب التعبيرات الاجتماعية السياسية للإسلام السياسي في علاقتها بالنّص:
1 ـ جماعة الإخوان المسلمين: هم ورثة خطاب الاصلاح والتيار السلفي في النهضة العربية وهم أهل السنّة والجماعة التي لا ترى من جماعة خارجها إلا زيغا عن الفهم السليم للإسلام ولهذا " ضيّقوا حدود النّص ونظروا اليه من زاوية واحدة اعتبروها هي الزاوية الصحيحة ونتائجها قطعية "( ص125). ورغم تعدد التنظيمات الموازية لرابطة جماعة الاخوان فإنّها جميعها كانت تعيش غياب وعي تاريخي يلغي دفعة واحدة ما بعد الخلافة الراشدة.
2 ـ حزب التحرير: ويمكن تلخيص الرأي فيه في قول الكاتب:" لقد زاوج حزب التحرير بين عنف الخطاب ـ التكفير ـ وخطاب العنف ـ اجبار الخليفة النّاس ـ فجاء خطابه كُليانيا لا يرى الحقّ إلا في ما يفرضه الخليفة باسم الأمّة والشرع ولا يرى في الآخر دورا إلاّ دفع الجزية فألغى بذلك حق الاختلاف والتعدد وغابت الحرية عن خطابه"( ص130)
3 ـ الاتجاه الإسلامي بتونس: يمكن اختزال أمره في ملاحظتين: أولهما أنّ مساره لم يكن في بدايته تصاعديا بل كان متأرجحا بحسب تكوين قياداته الأولى لهذا جاء متوترا متضاربا أحيانا. وثانيهما أنّ البعد السياسي واتساع النزعة البراقماتية قد تضخّمتا في غير انسجام مع تكوين قواعده.
باختصار ظلّت هذه التعبيرات من الإسلام السياسي تبحث عن وحدة الأمّة وهي لم تحقق وحدتها الداخلية. يقول الكاتب :" لقد آن الأوان للحركة الإسلامية أن تعي أنّ الوحدة الحقيقية لا تعني توحيد العقول وصهرها ضمن أنساق مغلقة"(ص 134).
يخصص الكاتب ثلاثة مقالات ترصد مراجعات حركة النهضة منذ تأسيسها حتى ما بعد الثورة التونسية: ففي مراحل التأسيس والجدّ في العلنية الحزبية مالت الحركة إلى تقريب المفاهيم الليبرالية من مفاهيم التراث ( شورى/ديمقراطية، حكم شرعي/حكومة مدنية، الرعية المسؤولة/ المواطنة...) غير أنّ صدامها مع النظام جعلها تتراجع عن الحلم السياسي إلى ما سمّته ب"فقه الواقع" حتى أنّها أصبحت تنظر إلى مختلف تجارب الحركات الإسلامية بمدى التزامها بالديمقراطية وضمان الحقوق وانجاز الرفاه الاجتماعي.
المراجعة الأهمّ هي الإقبال على محاورة العلمانيين بل للغنوشي اجتهاد في "علمانية الحكم في الإسلام" وأصبحت عنده مسألة الحرية مركزا في أطروحاته. وهذا ما قاد حركته إلى التخلّي عن نموذج "الدولة الدينيّة " إلى مدنيّتها ومساواة مواطنيها أمامها.
آخر المراجعات تمّت بعد الثورة وكتابة دستور مدني توافقي يضمن الحرية الفردية وحرية المعتقد والضمير ومدنية الدولة فقطعت الحركة مع الإسلام السياسي وذلك في مؤتمرها العاشر في ماي سنة 2016 ب"فصل الدعوي عن السياسي" وبلورة ما سمّي بـ"الإسلام الديمقراطي". وقد ظهر هذا أكثر في دستور 2014 وما أثير حوله من شبهة "أسلمة الدستور" وخاصة ما أثاره فصله الأوّل حول: دين الدولة أم دولة دينية؟ وعلاقته بالشريعة مصدرا للتشريع.
أمّا الباب الرابع فقد خصّصه السيد لطفي حجّي لظاهرة التكفيريين الجهاديين ودوّامة العنف التي أغرقت ثورات الربيع العربي وساهمت في تشويه صورة الإسلام وما استتبع هذا من علاقة بفضاء المسجد باعتباره فضاء عاما. لكن الطريف في هذه المقاربة ليس ما قيل فيها من نزوعها إلى تهديم أسس الدولة بل ما أشار إليه الكاتب في مقابل هذا ممّا سمّاه ب" التكفير باسم الحداثة " كما مثّله السلفية البورقيبيّة أو غيرها من الدوغمائية الايديولوجية.
في الحاجة إلى إعادة التأسيس
يخصّص الكاتب بابيه الأخيرين لجدل الفكر والواقع تناسبا مع اعتقاده في الفكر المقاصدي وذلك بتحقيق نوع من المزاوجة المُخصبة بين المنجز المدني الإنساني والعقلاني في الحقوق والحريات مع النّص المقدّس في تخريجة طريفة استعارها الكاتب من المفكّر محمّد الطالبي وسمّاها "القراءة السهمية للقرآن"( ص362) وهي تقوم على استعادة روح القرآن وتنسيب اطلاقية كل القراءات. ويرفد لطفي حجّي هذه الفكرة بمشروع المفكّر المغربي محمد عابر الجابري في نقد العقل العربي تكوينا وبنية وخطابا، في دعوة صريحة إلى إعادة التأسيس.
نعتقد أنّ ما طرحه لطفي حجّي من فكرة أو ظلال فكرة نظرا لطبيعة المقالة الصحفيّة من نزعة للتلخيص والاختزال حريّ بالتوقّف عند ثلاث أفكار مهمّة:
الفكرة الثانية الحَريّة بالتوقّف هي الخطاب الديني المعاصر الذي بدا من وجهة نظر الكاتب "غريبا كصالح في ثمود". وإن بدا لنا السبب في هذا من جهتنا عائد إلى كونه خطابا توفيقيا أقرب إلى "الحيلة الذهنية العارضة" لفكرة الوسطية التي لا تكاد تحسم في شيء، فإنّ ما يطرحه الكاتب من حلول به وعليه يضيع في ظلّ التوتّر العظيم بين أمزجة أهل السياسة في بلد تابعٍ ومتخلّف فكريا وحضاريا.
إنّ كتاب "إسلام السلطة وإسلام الجماعة" للصحفي لطفي حجّي ـ وهذه ثالثة الأثافي ـ يضعنا داخل سياق تحوّلات القرن الواحد والعشرين رصدا ومقاربة ونقدا ليكون ورقة عمل مهمّة تثير الإشكاليات الكبرى وتطرح الأسئلة الحارقة تقوم على رأسها مسألة الحريّة التي لا يمكن أن تقوم نهضة إلاّ في ظلّها ولا يمكن حلّ التناقضات إلاّ بضمان حقّ الاختلاف بواسطتها. ولأنّ أنظمة الدول الوطنيّة ما بعد الاستقلال على امتداد الخريطة العربيّة قد تحوّلت إلى أنظمة مغلقة خائفة فإنّها ـ وبلا استثناء ـ قد شهدت تاريخا من القمع والملاحقة لكلّ مخالف سواء في ذلك الأنظمة المغلفة بالدين أو المستندة على الفكرة القومية ملوكا ورؤساء وقادة انقلابات. لهذا سيظلّ مطلب الحرية هو أهمّ أشواق الشعوب العربيّة.
لطفي حجّي هو خرّيج معهد الصحافة التونسيّة مؤلّف كتاب "بورقيبة والإسلام: الزعامة والإمامة" (2004) الذي وقعت ترجمته إلى الفرنسية سنة 2011 كما شارك في مؤلّف جماعي حول "بورقيبة: البصمة والأثر" مثلما ساهم في مؤلف جماعي حول مراجعات الإسلاميين سنة 2010 وفي تقارير حول حرية الإعلام وكان أحد مؤسسي هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات سنة 2005 التي أقامت أوّل منبر بتونس للحوار بين الإسلاميين والعلمانيين وبادر بصياغة نصوصها المرجعية حول المساواة بين الجنسين وحرية الضمير والمعتقد والعلاقة بين الدين والدولة التي تحوّلت إلى مبادئ دستور 2014 لتونس بعد الثورة.
الكتاب
يتضمّن مقدمة وستّة أبواب في تعدد أفهام الإسلام وعلاقة مقولة الشورى بالديمقراطية وما طرأ على فهم الجماعات للإسلام من مراجعات قبل ثورات الربيع العربي وبعدها. ثمّ يقارب ظاهرة التكفيريين ليضعنا أمام "تيه المسلم " اليوم بين النص والعقل/ التأويل والواقع لينتهي عند أفق تجديد الفهم الديني. الكتاب متوسّط الحجم يقع في 404 من الصفحات وهو يتدرّج منهجيا من تفكيك المقولات الكبرى للفكر الإسلامي إلى ما صدق عليها من وقائع في أسلوب صحفي دقيق العبارة حذر التأويل رصين الاستنتاج.
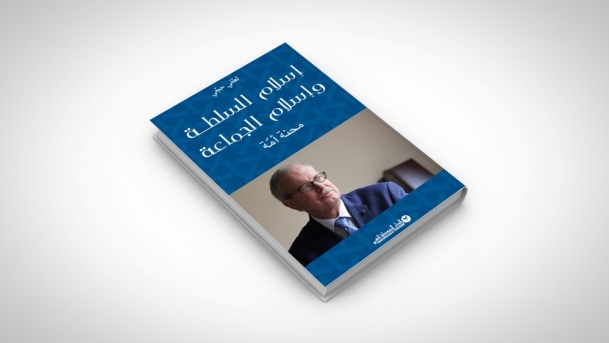
يأخذ الكتاب بمسألة حضارية غاية في الأهميّة، هي "محنة أمّة" يلخّصها الكاتب في قوله " مأزق فهم الإسلام في ديار الإسلام" كما ورد في المقدّمة. ومن هناك يفتح أبوابا ظلّت مواربة لم يُحسم فيها قول بلّ زادت تعقيدا مع ظهور الفهم الدموي للعقائد كأنّنا في زمن "حسن الصباح" والحشاشين.
الإسلام الواحد والأفهام المتعددة
يُفتح الباب الأوّل على المفارقة: الإسلام الواحد والأفهام المتعددة. بما يؤشّر على تأصّل الاختلاف المذهبي والعقائدي والسياسي وبدايات ظهور فكرة "الفرقة النّاجية" التي شرّعت للتقاتل والتناحر بتوظيف التأويل والفهم الحدّي للإسلام. ولكن هذه الحديّة لم تسلم منها السلطة السياسية المعاصرة ولا الجماعات الحاملة للفكرة الدينية. وكلاهما بشكل أو بآخر يوظّف الدين لصالحه ويفهمه على طريقته ويستعدي به الفهم الآخر. عند هذا الحدّ يطرح المؤلّف مسألة الحريّة باعتبارها الضامن الوحيد لتجنّب ما سماه "التضليل الفكري": "فالحرية الدينيّة ستسمح بتعايش التأويلات والاجتهادات دون أن يحتكر طرف ـ جماعة أو سلطة ـ حق تأويل الدين وتقنين التفكير حوله" ( ص31).
المراجعة الأهمّ هي الإقبال على محاورة العلمانيين بل للغنوشي اجتهاد في "علمانية الحكم في الإسلام" وأصبحت عنده مسألة الحرية مركزا في أطروحاته. وهذا ما قاد حركته إلى التخلّي عن نموذج "الدولة الدينيّة " إلى مدنيّتها ومساواة مواطنيها أمامها.ودون تجاوز المفارقة أعلاه يصبح من الضروري الإقرار بأنّ "الاصلاح ـ يقصد الاصلاح الديني ـ بات ضروريا مع ثورة المعلومات حتى لا يهمّش الدين"( ص38) وهو ما سمح للمؤلّف بتقرير مبدإ هو بمثابة الثابت في الفهم المقاصدي للإسلام وهو ربط مقاصد النّص بروح العصر متخيّرا أكثر من مثال قديم في هذا الباب ممّا أُبطل من حدود تحت ضغط الواقع ( ص39) وينغلق الباب على ما سمّاه ب"فقه الحريات ":" نحن في أمسّ الحاجة إلى فقه جديد قد نسميه فقه الحرية الذي يسمح للجميع بحرية التأويل والقراءة مع الاقرار بحق الاختلاف وحق التعايش"( ص48)
الديمقراطية والشورى
يتضمّن هذا الباب اختبارات فكرية لمقولات الليبرالية المعولمة في الدين والسياسة ومنها فقه الشورى ومؤسسات الديمقراطية، ومنها "الفريضة الغائبة" من الديمقراطية المغشوشة، ومنها فكرة المواطنة في ظلّ نظم تيوقراطية أو عسكرية ترى في مواطنيها رعايا، ومنها ما طرأ على الدول الوطنية من انحرافات نحو التسلّط والغنائمية في تعاملهم مع السلطة والدولة.
زمن المراجعات
هذا العنوان يجمع بابين وهما الثالث والرابع من الكتاب. ينطلق الكاتب من مقدّمة قائمة على خيارين وجدت الحركات الإسلامية نفسها أمامهما وهما: إمّا بناء خطاب بوعي نقدي من أجل رؤية تأليفية تذيب تناقضات الأمس أو أن تختار تيارا سواء رسميا أو معارضا( سنّي أموي أو خارجي أو غيرهما) واعتبار نفسها امتدادا له. ولقد اختارت الثّاني ف"ساهمت في تعقيد المعادلة بدل حلّها"(ص118). من هنا يعرض الكاتب التعبيرات الاجتماعية السياسية للإسلام السياسي في علاقتها بالنّص:
1 ـ جماعة الإخوان المسلمين: هم ورثة خطاب الاصلاح والتيار السلفي في النهضة العربية وهم أهل السنّة والجماعة التي لا ترى من جماعة خارجها إلا زيغا عن الفهم السليم للإسلام ولهذا " ضيّقوا حدود النّص ونظروا اليه من زاوية واحدة اعتبروها هي الزاوية الصحيحة ونتائجها قطعية "( ص125). ورغم تعدد التنظيمات الموازية لرابطة جماعة الاخوان فإنّها جميعها كانت تعيش غياب وعي تاريخي يلغي دفعة واحدة ما بعد الخلافة الراشدة.
2 ـ حزب التحرير: ويمكن تلخيص الرأي فيه في قول الكاتب:" لقد زاوج حزب التحرير بين عنف الخطاب ـ التكفير ـ وخطاب العنف ـ اجبار الخليفة النّاس ـ فجاء خطابه كُليانيا لا يرى الحقّ إلا في ما يفرضه الخليفة باسم الأمّة والشرع ولا يرى في الآخر دورا إلاّ دفع الجزية فألغى بذلك حق الاختلاف والتعدد وغابت الحرية عن خطابه"( ص130)
3 ـ الاتجاه الإسلامي بتونس: يمكن اختزال أمره في ملاحظتين: أولهما أنّ مساره لم يكن في بدايته تصاعديا بل كان متأرجحا بحسب تكوين قياداته الأولى لهذا جاء متوترا متضاربا أحيانا. وثانيهما أنّ البعد السياسي واتساع النزعة البراقماتية قد تضخّمتا في غير انسجام مع تكوين قواعده.
باختصار ظلّت هذه التعبيرات من الإسلام السياسي تبحث عن وحدة الأمّة وهي لم تحقق وحدتها الداخلية. يقول الكاتب :" لقد آن الأوان للحركة الإسلامية أن تعي أنّ الوحدة الحقيقية لا تعني توحيد العقول وصهرها ضمن أنساق مغلقة"(ص 134).
يخصص الكاتب ثلاثة مقالات ترصد مراجعات حركة النهضة منذ تأسيسها حتى ما بعد الثورة التونسية: ففي مراحل التأسيس والجدّ في العلنية الحزبية مالت الحركة إلى تقريب المفاهيم الليبرالية من مفاهيم التراث ( شورى/ديمقراطية، حكم شرعي/حكومة مدنية، الرعية المسؤولة/ المواطنة...) غير أنّ صدامها مع النظام جعلها تتراجع عن الحلم السياسي إلى ما سمّته ب"فقه الواقع" حتى أنّها أصبحت تنظر إلى مختلف تجارب الحركات الإسلامية بمدى التزامها بالديمقراطية وضمان الحقوق وانجاز الرفاه الاجتماعي.
المراجعة الأهمّ هي الإقبال على محاورة العلمانيين بل للغنوشي اجتهاد في "علمانية الحكم في الإسلام" وأصبحت عنده مسألة الحرية مركزا في أطروحاته. وهذا ما قاد حركته إلى التخلّي عن نموذج "الدولة الدينيّة " إلى مدنيّتها ومساواة مواطنيها أمامها.
آخر المراجعات تمّت بعد الثورة وكتابة دستور مدني توافقي يضمن الحرية الفردية وحرية المعتقد والضمير ومدنية الدولة فقطعت الحركة مع الإسلام السياسي وذلك في مؤتمرها العاشر في ماي سنة 2016 ب"فصل الدعوي عن السياسي" وبلورة ما سمّي بـ"الإسلام الديمقراطي". وقد ظهر هذا أكثر في دستور 2014 وما أثير حوله من شبهة "أسلمة الدستور" وخاصة ما أثاره فصله الأوّل حول: دين الدولة أم دولة دينية؟ وعلاقته بالشريعة مصدرا للتشريع.
أمّا الباب الرابع فقد خصّصه السيد لطفي حجّي لظاهرة التكفيريين الجهاديين ودوّامة العنف التي أغرقت ثورات الربيع العربي وساهمت في تشويه صورة الإسلام وما استتبع هذا من علاقة بفضاء المسجد باعتباره فضاء عاما. لكن الطريف في هذه المقاربة ليس ما قيل فيها من نزوعها إلى تهديم أسس الدولة بل ما أشار إليه الكاتب في مقابل هذا ممّا سمّاه ب" التكفير باسم الحداثة " كما مثّله السلفية البورقيبيّة أو غيرها من الدوغمائية الايديولوجية.
في الحاجة إلى إعادة التأسيس
يخصّص الكاتب بابيه الأخيرين لجدل الفكر والواقع تناسبا مع اعتقاده في الفكر المقاصدي وذلك بتحقيق نوع من المزاوجة المُخصبة بين المنجز المدني الإنساني والعقلاني في الحقوق والحريات مع النّص المقدّس في تخريجة طريفة استعارها الكاتب من المفكّر محمّد الطالبي وسمّاها "القراءة السهمية للقرآن"( ص362) وهي تقوم على استعادة روح القرآن وتنسيب اطلاقية كل القراءات. ويرفد لطفي حجّي هذه الفكرة بمشروع المفكّر المغربي محمد عابر الجابري في نقد العقل العربي تكوينا وبنية وخطابا، في دعوة صريحة إلى إعادة التأسيس.
نعتقد أنّ ما طرحه لطفي حجّي من فكرة أو ظلال فكرة نظرا لطبيعة المقالة الصحفيّة من نزعة للتلخيص والاختزال حريّ بالتوقّف عند ثلاث أفكار مهمّة:
آخر المراجعات تمّت بعد الثورة وكتابة دستور مدني توافقي يضمن الحرية الفردية وحرية المعتقد والضمير ومدنية الدولة فقطعت الحركة مع الإسلام السياسي وذلك في مؤتمرها العاشر في ماي سنة 2016 ب"فصل الدعوي عن السياسي" وبلورة ما سمّي بـ"الإسلام الديمقراطي".أوّلهما هي المسألة العلمانية والمشتركات الوطنية التي بدت لي أنّها هاجس من هواجس الكاتب تكاد تحضر بشكل أو بآخر في أغلب المقالات. فعلمنة الحياة السياسية ـ أمّا الفكرية فهي واقع لا محالة ـ قد ولدت مشوّهة عرجاء لكونها مستنسخة عن دولة الإدارة الاستعمارية. هذا ما لم يصرّح به الكاتب وإنما قصد إلى مظاهرها واستتباعاتها وتأثيرها في إذكاء الصراع الذي حكم البلد وأدخلها في شدّ وجذب ومغالبة بين محافظين لم يطوّروا من أطروحاتهم وحداثيين اختطفوا الدولة الوطنيّة ليحاربوا بها ظاهرة الإسلام السياسي. هذا الصراع في تونس أخذ مسميات متعددة على مدى تاريخها الحديث( تغريبيون/ أصوليون، علمانيون/ متدينون، تنويريون/ ظلاميون، حداثيون/ محافظون) ولن يهدأ هذا التوتر إلا بالالتقاء حول المشتركات الوطنيّة التي لا تتحقّق إلا بشرط قيام "علمانيّة غير متطرّفة".
الفكرة الثانية الحَريّة بالتوقّف هي الخطاب الديني المعاصر الذي بدا من وجهة نظر الكاتب "غريبا كصالح في ثمود". وإن بدا لنا السبب في هذا من جهتنا عائد إلى كونه خطابا توفيقيا أقرب إلى "الحيلة الذهنية العارضة" لفكرة الوسطية التي لا تكاد تحسم في شيء، فإنّ ما يطرحه الكاتب من حلول به وعليه يضيع في ظلّ التوتّر العظيم بين أمزجة أهل السياسة في بلد تابعٍ ومتخلّف فكريا وحضاريا.
إنّ كتاب "إسلام السلطة وإسلام الجماعة" للصحفي لطفي حجّي ـ وهذه ثالثة الأثافي ـ يضعنا داخل سياق تحوّلات القرن الواحد والعشرين رصدا ومقاربة ونقدا ليكون ورقة عمل مهمّة تثير الإشكاليات الكبرى وتطرح الأسئلة الحارقة تقوم على رأسها مسألة الحريّة التي لا يمكن أن تقوم نهضة إلاّ في ظلّها ولا يمكن حلّ التناقضات إلاّ بضمان حقّ الاختلاف بواسطتها. ولأنّ أنظمة الدول الوطنيّة ما بعد الاستقلال على امتداد الخريطة العربيّة قد تحوّلت إلى أنظمة مغلقة خائفة فإنّها ـ وبلا استثناء ـ قد شهدت تاريخا من القمع والملاحقة لكلّ مخالف سواء في ذلك الأنظمة المغلفة بالدين أو المستندة على الفكرة القومية ملوكا ورؤساء وقادة انقلابات. لهذا سيظلّ مطلب الحرية هو أهمّ أشواق الشعوب العربيّة.
0
المزيد حول هذا الموضوع
في هشاشة الديمقراطية المغربية قبل انتخابات 2016.. مسيرة "ولد زروال" نموذجا
27-May-24 11:42 AM
محطة "البلوكاج" بالمغرب.. خلفيات عرقلة تشكيل حكومة بنكيران الثانية
30-Apr-24 12:42 PM

